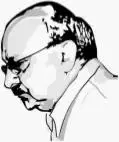«من مرج الزهور إلى طوفان الأقصى»: فاطمة الصمادي توثّق علاقة إيران وحماس

لعل العلاقة بين حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وجمهورية إيران الإسلامية أبرز شاهد على سمة تغلّب التحيّز السياسي على الفهم الموضوعي في القراءة السياسية العربية السائدة.
فالترميز الطائفي لهذه العلاقة، كون طرفيها على اختلاف مذهبي، والقوة الأيديولوجية، والشرعية السياسية والأخلاقية للقضية الفلسطينية، جعلت النظرة إلى هذه العلاقة تسقط في فخ التصور الرغبوي للعواطف السياسية العربية المستنفرة والمتناقضة، وكذلك للمصالح السياسية لكل طرف، سواء المريد لها أم الخصم. أسهم في ذلك أنها في ذاتها علاقة معقّدة، فطرفاها، من إيران الثورة والمقاومة الإسلامية، لا يندرجان في قوالب التحليل السياسي المعلّب، المستعار في جلّه من الأكاديميا الغربية، والمعتمد على مصادر مكتوبة وثانوية لا تخلو من التحيّز السياسي والثقافي. بل يستعدي فهمهما إلى توليد إطار نظري خاص، يستعدي بدوره جهداً بحثياً أصيلاً وميدانياً قلّما نراه، رغم حاجتنا الماسة إليه عربياً لفهم أوضاعنا وأحوالنا.
ينجح هنا مؤلَّف الدكتورة فاطمة الصمادي «إيران وحماس... من مرج الزهور إلى طوفان الأقصى: ما لم يروَ من القصة» (2024، مركز الجزيرة للدراسات) في تقديم مجهود بحثي ميداني أصيل، من إجراء المقابلات والسبر في الأرشيف، إلى إعطاء إطلالة مهمة على الإنتاج الأكاديمي باللغة الفارسية. إن هذا الطابع الميداني هو ما يؤهّل الدراسة، بشكل رئيسي، أن تكون اختراقاً جديراً بإنهاء حالة دوامة الجدل المتكرّر عربياً حول طبيعة العلاقة بين إيران وحماس، أقلّه لمن أراد ذلك، وكانت لديه الأمانة الأخلاقية والعلمية.
لعل أهم ما يقدّمه الكتاب ليس فهم العلاقة بين الطرفين فحسب، بل فهم كل طرف عبر فهم تلك العلاقة
بالإضافة إلى ذلك، تقدّم الدراسة إطاراً نظرياً مستقلاً لفهم نمط هذه العلاقة، وهو ما تصفه الصمادي بـ«الإطار المركّب»، حيث تأخذ البنية الفكرية والأيديولوجية والأدوات الخطابية للطرفين، دون إغفال طابع المصالح السياسية والأدوار والنفوذ. إذ إنها تجادل من جديد في ركاكة نموذج علاقة الوكالة، فلا إيران ولا حماس يتصرفان كطرفي هذا النموذج في ممارستهما السياسية، وهو ما تكشف عنه الصمادي عبر تفكيك معمق للبنية التاريخية والفكرية لكل طرف، ثم لتتبعه بسرد مفصّل، وعلى لسان الشخصيات التي عايشته، لمسار علاقتهما منذ بدايتها.
يوفّر الكتاب استعراضاً مهماً وطويلاً لتاريخ العلاقة الإيرانية بالقضية الفلسطينية وتحولاتها، منذ نهاية العهد القاجاري ثم البهلوي وصولاً إلى الجمهورية الإسلامية وبمحطاتها وتحولاتها المختلفة على مدار أربعة عقود.
أسهم هذا السرد في بناء خلفية مهمة للقارئ في التعاطي مع هذه العلاقة وتطورها في فهم البنية التحتية السياسية للدولة ومؤسساتها والمجتمع وتياراته في إيران. وكذلك، عدم اندراج هذه العلاقة ضمن الحيز الكلاسيكي للعلاقات الدولية، بل إن القضية الفلسطينية، بمضمونها كحالة استعمارية، هي جزء من توليفة الأيديولوجيات السياسية المحلية في إيران. وهي سمة لهذه القضية تشهدها غالبية دول العالم، من الدول الإسلامية إلى أميركا اللاتينية، بل في الغرب ذاته، وبما ينعكس على طبيعة علاقة أي دولة مع فلسطين والحركات السياسية فيها.
إن أحد جوانب أهمية الكتاب هو تقديمه فرصة للقارئ لإعادة زيارة المحطات التاريخية المختلفة وبشكل بانورامي، وبتفاصيل صغيرة، ما يشكل فرصة لإعادة النظر للأحداث، بخطوة من الخلف، ودون غشاوة عواطف تلك اللحظة الزمنية.
من هنا تأخذنا الصمادي في رحلة، وبسرد ذي طابع قصصي سلس، لنشأة العلاقة بين إيران وحماس منذ أول تواصل بين الطرفين؛ الفرصة الذهبية التي وفّرها -للمفارقة- الإبعاد إلى مرج الزهور، حيث يمكننا النص من التنقّل بين المصادر الإيرانية ومصادر حماس من رؤية الأحداث من منظور كل طرف، وردات فعلهم، وتصوراتهم عن بعضهم البعض، في مرحلة تعارف غلب عليها التردد من الطرفين لبناء الثقة.
ثم تنتقل بنا إلى محطاتها المتعددة والعاصفة عصفاً يضع تماسك نظرية «الوكالة» في وضع صعب؛ ففي حين تماسك التوافق الإستراتيجي في العناوين العامة فإن الاختلاف التكتيكي كان حالة متكررة، من الموقف من الغزو الأميركي للعراق والذي وقف فيه حزب الله وحماس في الخانة ذاتها، إلى اعتراض إيران على مشاركة الحركة في انتخابات عام 2006، ثم التباين حول قرار الحسم العسكري في غزة، إلى الأزمة الأطول والأكبر على خلفية الحدث السوري وصولاً إلى «طوفان الأقصى».
في السياق ذاته، تكشف العلاقة بين الأداء العسكري للمقاومة وزيادة الدعم الإيراني على إثرها عن الوجه الدولتي للحسابات العقلانية الإيرانية، وكذلك تباين وجهات نظر مؤسسات الحكم في إيران، المعطوفة بدورها على بعد أيديولوجي في الصراع ضد الكيان الصهيوني حيث لم تنعكس حدة الخلافات السياسية بالنسبة ذاتها على العلاقة مع الجهاز العسكري للحركة، أي «كتائب القسّام».
إنّ ما يكشفه الكتاب، بنظرة عامة، هو تعقيد الاعتبارات الداخلية والخاصة لكل طرف، وهو ما انعكس تعقيداً على علاقة الطرفين. فلعل أهم ما يقدّمه الكتاب ليس فهم العلاقة بين الطرفين فحسب، بل فهم كل طرف عبر فهم تلك العلاقة؛ فعبر هذه العلاقة تستطيع فهم العقلية الإيرانية وتركيبها، وأيضاً، والأهم بالنسبة إلينا، فهم عقلية حركة حماس ومنظورها وحساباتها السياسية وتبايناتها الداخلية، وهو فهم مهم اليوم في ظل الثقل السياسي العربي والإقليمي للحركة بعد «طوفان الأقصى».
تسعى الحركة إلى بناء شبكة علاقات واسعة وغير مشروطة للكل العربي والإسلامي بلا استثناء، وعلى نحو تحرص فيه على عدم تضارب أطراف هذه الشبكة واختلافاتهم البينية الخاصة. ففي الأخير، تحمل الحركة على عاتقها ثقل المشروعية والرمزية الكبرى للقضية الفلسطينية والتي تمثل عامل جذب لمختلف الأطراف لاستقاء المشروعية السياسية منها. إن هذا السعي ليس بالأمر الهيّن ويستدعي إدارة دقيقة وحساسة.
يختتم الكتاب بعنوان ذي تساؤل كبير: «هل خذل محور المقاومة حركة حماس؟» فتستعرض الكاتبة مرحلة «الطوفان» كإحدى مراحل التحديات التي واجهت العلاقة، وإن كان من نوع مختلف عن مرحلة الأزمة السورية.
وهو تحدٍّ لم يخلُ من التباينات في طبيعة إدارة المعركة، وتبايُن الطرفين في حجم مشاركة المحور، مع قراءة مختلفة لحركة أنصار الله، إلا أن المحصلة النهائية كما تؤكد الحركة أن «الطوفان» سيدفع بالعلاقة إلى مستويات أعلى. ففي الأخير، لم تشذ مرحلة «الطوفان» عن طبيعة العلاقة، عاكسة الحيثية الخاصة للطرفين، فلم تكن سوى فصل من فصولها، وهي العلاقة التي وإن مرّت بمراحل حرجة إلا أنها وكما تؤكد الدكتورة نجحت في التماسك لحرص كل من الجنرال قاسم سليماني والقائد محمد الضيف عليها، وعلى إثر ذلك لتستمرّ، بتعبير الصمادي، فصول القصة حتى التحرير.
* كاتب عربي